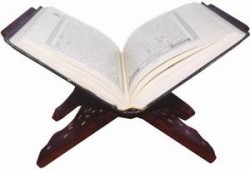بينما كنت أقلِّب في أوراقي القديمة وجدت تلخيصًا لرسالة العبودية، كنت قد أعددته منذ حوالي 40 سنةً، فرأيت أن أقدِّم له وأنشره لينتفع به الناس؛ حيث إن هذه الرسالة- على إيجازها- من أنفع ما كُتب في هذا الباب، ولا يزال كبار العلماء يرجعون إليها وينقلون منها حتى الآن، وإليكم المقدمة ثم التلخيص:
مقدمة
إن كلمةَ العبودية كلمةٌ كريهةٌ للنفوس لأول وهلةٍ، وهي كذلك إن كانت العبوديةُ مفروضةً من الإنسان على أخيه الإنسان، ولقد تعرض البشر في تاريخهم الطويل- ولا يزالون- لاستعباد القويِّ الضعيفَ، والغنيِّ الفقيرَ، وصاحبِ السلطان من لا سلطان له، بل تعرَّضت دولٌ لاحتلال دولٍ أخرى واستعبادها، ولذلك أُفعِمت هذه الكلمة بهذا القدر من الكراهية، وأُشرِبت النفوس حبَّ الحرية، حتى قيل: (حرِّيتُك أثمنُ من حياتك)، ولقد بُذلت نفوسٌ وسالت دماءٌ عبر التاريخ في سبيل الحرية، حتى قال شوقي:
وَلِلْحُريَّةِ الحَمْرَاءِ بَابٌ بِكُلِّ يَدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ
كذلك إذا كانت العبودية من إنسانٍ لإنسان.
بيْد أن هناك عبوديةً حبيبةً للقلوب، رافعةً للكرامة، جالبةً للشرف، محققةً لغنى النفوس، ألا وهي العبودية لله واهبِ الحياة وواهبِ الرزق، وواهب العقلِ وواهبِ الهداية، وواهبِ الصحة وواهبِ الولد؛ ولذلك لا يمكن أن تكون العلاقة بين الإنسان وبين ربه إلا علاقة العبودية.
وهذه العبودية هي الغاية التي من أجلها خُلقت الحياة ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)﴾ (الذاريات)، هذا التصور الإسلامي للحياة وللإنسان ولدوره وغايته كفيلٌ باستقامة سلوك الفرد على منهج الله، ونظام المجتمع على شريعة الله؛ الأمر الذي من شأنه أن يحقق السعادة في الدنيا وفي الآخرة.
هذه العبودية التي تزيد المرء شرفًا وكرامةً وفخرًا، كما قال القائل:
وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا وَكِدْتُ بِأَخْمُصِي أَطَأُ الثُرَيَّا
دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبِادِي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا
فما هي العبادة؟، وما حقيقتها؟، وما شروطها؟، وما نواقضها؟
فإلى الملخص؛ عساه يكون مجيبًا عن هذه التساؤلات، دافعًا للرجوع إلى الرسالة ذاتها:
الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه.
وبعد..
فالعبادة هي اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ فالصلاة والزكاة، والصيام والحج، وصدق الحديث وأداء الأمانة، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل، والرحمة حتى بالبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له والصبر لحكمه، والشكر لنعمه والرضا بقضائه، والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله".
وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له، التي خلق الخلق لها، قال تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56)، وبها أرسل جميع رسله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء: 25)، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: من الآية 36).
وجعل العبادةَ لازمةً لرسوله وصفوةِ خلقه- صلى الله عليه وسلم- حتى الموت، فقال تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: 99)، وبالعبادة نَعَتَ أحبَّ الخلق إليه، فقال في حق الملائكة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (لأعراف: 206)، وقال في حق الصالحين من عباده: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ (الإنسان: 6)، وقال: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾ (الفرقان: 63)، وقال في شأن المسيح الذي نُسبت إليه الألوهية والبنوة ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (الزخرف: 59)، ولهذا قال المصطفى- صلى الله عليه وسلم-: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبدٌ، فقولوا: عبد الله ورسوله".
ولقد وصف الله تعالى رسوله- صلى الله عليه وسلم- بالعبودية في أشرف المواقف وأكمل الأحوال، فقال في سورة الإسراء: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ (الإسراء: من الآية 1)، وقال في الإيحاء: ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ (لنجم: 10)، وقال فى الدعوة: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ (الجن: 19)، وقال فى التحدي ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ﴾ (البقرة: من الآية 23).
فالدين كله داخلٌ في العبادة، وقد ثبت فى الصحيح أن جبريل لمَّا جاء إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- في صورة أعرابي، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان في الحديث المشهور، قال- عليه الصلاة والسلام- في آخر الحديث: "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"، فجعل هذا كله من الدين.
المعنى اللغوي لكلمتي الدين والعبادة يدل على أنهما وجهان لحقيقة واحدة
الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال: دنته فَدَانَ، أي أذللته فذلَّ، ويقال: ندين الله وندين لله، أي نعبده ونطيعه ونخضع له، فدين الله: عبادته وطاعته والخضوع له.
والعبادة معناها الذل أيضًا، يقال: طريقٌ مُعبَّدٌ إذا كان مذللاً وطئته الأقدام.
ولكن العبادة المأمور بها شرعًا تتضمَّن معنى الذل ومعنى الحب؛ فهي تتضمن غاية الذل لله- تعالى- بغاية المحبة له.
فالخضوع مع البغض ليس عبادةً، والحب مع عدم الخضوع ليس عبادةً، ولا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله، وكل محبة تعظيم لغير الله وبغير أمره باطلةٌ وفاسدةٌ، ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة: 24).
وكلمة العبد يراد بها معنيان: الأول: المُعبَّد الذي عبَّده الله أي ذلَّله وصرفه، ودبَّر كافة أموره والناس كلهم، بهذا المعنى فعباد الله هم جميعًا مخلوقون له، مرزوقون منه، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته طرفةَ عين ولا قيدَ شعرة، وجودُهم بأمره ومصيرُهم إليه، وفي هذا النطاق يدخل المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والصالح والطالح، والناس جميعًا لا يزالون يقرون لله بهذا الحق، وهو ما يسمَّى بـ"توحيد الربوبية" ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ﴾ (لقمان: من الآية 25)، ﴿قُلْ لِمَنْ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ للهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ للهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ للهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ (89)﴾ (المؤمنون).
وهذا النوع من العبودية لا يفرِّق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير به الإنسان مؤمنًا.
المعنى الثاني لكلمة العبد هو العابد، فيكون عابدًا لله بإرادته واختياره، لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين، ويعادي أعداءه الكافرين.
وهذه العبادة متعلِّقة بألوهية الله- تعالى-؛ ولذا كان عنوان التوحيد "لا إله إلا الله".
والإله لغةً: هو الذي يؤلِّهه القلب بكمال الحب والتعظيم، والإجلال والإكرام، والخوف والرجاء ونحو ذلك.
وهذا ما يسمَّى بتوحيد الألوهية، أي اعتقاد أن الله- سبحانه- وحده هو الحقيق بالعبادة المطلقة بمعناها الشامل، والالتزام بهذه العبادة عملاً وسلوكًا.
وهذا النوع من العبودية ينبني على توحيد الربوبية، ويصير بهما معًا الإنسان مؤمنًا، ويُفرق بهما بين أهل الجنة وأهل النار.
والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحدٌ، ولها أصلان:
أحدهما: ألا يُعبد إلا الله، والثاني: ألا يُعبد إلا بما أمر وشرع، لا يعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع، قال- تعالى-:﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: من الآية 110)؛ فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبَّه الله ورسولُه، وهو ما أمر به أمرَ إيجابٍ أو استحبابٍ.
فما كان من البدع فى الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها- وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل- ليست مشروعةً؛ فإن الله لا يحبُّها ولا رسولُه، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح، كما أن من يعمل ما لا يجوز- كالفواحش والظلم- ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح.
وأما قوله: ﴿وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: من الآية 110)؛ فهو إخلاص الدين لله وحده، وكان عمر بن الخطاب يقول: "اللهم اجعل عملي كلَّه صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا".
وقال الفضَيْل بن عياض في قوله- تعالى- ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ (الملك: من الآية 2)، قال: "أخلصه وأصوبه"، قالوا : يا أبا على.. ما أخلصه وأصوبه؟، قال: "إن العمل إذا كان خالصًا، ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة".
والناس يتفاوتون فى حقيقة الإيمان وحقيقة العبودية تفاوتًا كبيرًا، ويتفاضلون تفاضلاً عظيمًا، والرِّق والعبودية فى الحقيقة هو رِقُّ القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده؛ ولهذا يقال: العبد حرٌّ ما قنع، والحر عبدٌ ما طمع.
ولما كان لا بد للعبد من رزق، فإذا طلبه من الله صار عبدًا لله فقيرًا إليه، وإذا طلبه من مخلوقٍ صار عبدًا لذلك المخلوق فقيرًا إليه؛ ولذلك يقول المصطفى- صلى الله عليه وسلم-: "تَعِسَ عبد الدرهم، تَعِسَ عبد الدينار، تَعِسَ عبد القطيفة، تَعِسَ عبد الخميصة، تَعِسَ وانتكس، وإذا شِيكَ فلا انتقش"؛ ولذلك حرَّم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سؤالَ المخلوقين في، الأصل ولم تبَح إلا للضرورة، قال- عليه الصلاة والسلام-: "لا تحل المسألة إلا لذي غُرمٍ مفظع، أو دمٍ مُوجِع، أو فقرٍ مُدقِع".
وإذا تعلَّق قلب الرجل بامرأةٍ يبقى أسيرًا لها، تتحكَّم فيه وتتصرَّف بما تريد، وهو في الظاهر سيِّدُها؛ لأنه زوجها، وعلى الحقيقة أسيرُها ومملوكها، فإن أسْرَ القلب أعظمُ من أسْرِ البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، والحرية حرية القلب، كما أن الغنى غنى النفس، قال- عليه الصلاة والسلام-: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس".
وكذلك طالب الرئاسة والمنصب قلبُه رقيقٌ لمن يعينه عليها، ولو كان فى الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات، ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيسٌ مطاعٌ، وفي الحقيقة عبدٌ مطيعٌ لهم.
والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تاركٌ لحقيقة عبادة الله، أما من عبد الله وحده فيرضيه ما يرضى الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه اللهُ ورسولُه، ويبغض ما أبغضه اللهُ ورسولهُ، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، وبذلك يتحرر من عبودية كل شيء سوى الله- تعالى-، ويكون قد استكمل الإيمان كما جاء فى الحديث: "من أحبَّ لله وأبغَض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان"
والمحبة ليست دعوًى بغير بينةٍ، ولكن لا بد لها من برهانٍ، هذا البرهان هو اتباع الرسول، والجهاد فى سبيل الله، يقول- تعالى-: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللهُ﴾ (آل عمران: من الآية 31)، ويقول: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ﴾ (التوبة: من الآية 24).
والعبودية تُناقِض الكبر، ولذلك جاء فى الحديث "لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر"، وإذا كانت العبادة هي غاية الخلق، وبها أرسل الله سائر رسله، وبها أمر جميع خلقه ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ (البقرة: من الآية 21)، وأوجبه على أفضل خلقه وخاتم رسله أن يلتزم بها حتى الموت ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: 99)، إذا كان هذا خطرها وأهميتها عند الله كانت- ولا ريب- أعلى المقامات، وأشرف الغايات التي ينبغي أن يتثبَّت بها، ويستشرف لها، ويتدرَّج ويتقلَّب فيها المسلم.
ضلالات عقدية وعملية تخرج عن حقيقة العبودية:
- يعتقد بعض الناس أن الإقرار لله وحده بالربوبية- أي بالخلق والرزق، والإحياء والإماتة، والهيمنة والتصرف في كل أجزاء الكون، وهو ما يعبِّر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية "بشهود الحقيقة الكونية"- يكفي حتى يُحسبَوا في عداد المؤمنين في ذات الوقت الذي لا يعترفون لله وحده بالألوهية- أي باستحقاقه وحده لكل أنواع العبادة وصورها- ولا يتوجهون بها إليه، وإذا توجهوا أشركوا معه فيها غيره، وخالفوا بذلك أمره ونهيه الشرعيين، وهو ما يعبِّر عنه المؤلف "بالحقيقة الدينية".
وذلك ضلالٌ؛ فإن إبليس كان مقرًّا بربوبية الله، وكان يذكر هذه الحقيقة بين يدي كل طلب من الله ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (ص: 79)، ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الحجر: 39)، ولكنه خرج عن حقيقة العبودية وهي الطاعة، وأيضًا فإن المشركين كانوا يشهدون لله بذلك ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ﴾ (لقمان: من الآية 25)، ولكنهم كانوا يشركون معه فى العبادة آلهةٍ يزعمونها معه.
- ويرى آخرون أن الله يتصرَّف في الكون بروبيته، فلا يقع شيء فيه إلا بمشيئته، وبالتالي فالمعاصي والمنكرات، بل والكفر يقع بقضاء الله وقدره، ومقتضى مشيئته، فيجب الاستسلام لتلك الأمور كلها وعدم الإنكار لها والرضا بها وموافقتها، وهذا الكلام مؤداه أن يسقط الأمر والنهي الشرعيان، أي التكاليف الشرعية كلها؛ وبذلك ينهدم مفهوم العبودية، وينعدم الفارق بين المؤمن والكافر، والطائع والعاصي، والبر والفاجر، وهذا الضلال منشؤه أن هؤلاء نظروا للحقيقة الكونية- أي حقيقة الربوبية وحدها- التي رتَّب الله بها النتائج على الأعمال خيرًا كانت هذه الأعمال أم شرًّا، محبوبةً له- سبحانه- أم مكروهةً، ولم ينظروا إلى الحقيقة الدينية، أي حقيقة الألوهية، أي الأمر والنهي الشرعيين اللذين يدلان على ما يحبه الله ويرضاه، وما يبغضه ويأباه، فينفذوا أوامره ومحبوباته، ويجتنبوا نواهيه ومكروهاته.
والواجب على العبد المسلم أن ينظر إلى كلتا الحقيقتين، فيلتزم بالأوامر ويحب المحبوبات، ويجتنب النواهي ويبغض المكروهات، وإذا أذنب استغفر لذنبه ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ (غافر: من الآية 55)، وبالنسبة لذنوب الآخرين فعليه أن ينكرها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين.
أما إذا نزلت به مصيبة فعليه أن يستسلم؛ لأنها من قدر الله والرضا بالقدر من تمام الرضا بالله ربًّا، والله عز وجل لم يسوِّ بين المؤمن والكافر، ولا البر والفاجر ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35)﴾ (القلم) ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21)﴾ (الجاثية).
وهذا يدل على أن هذه الأعمال أو هذه الأوصاف لا تستوي عند الله؛ لأنه يحب ما أمر به منها، ويكره ما نهى عنه منها، وهذا مقتضى ألوهيته، وإن كانت كلها واقعةً بقدره ووفق مشيئته أي بربوبيته.
- وثمة عقيدتان إحداهما تسمَّى بالحلول والأخرى بوحدة الوجود؛ الأولى معناها أنه من الممكن أن تحلَّ ذات الله في شخص بعينه، وعبر عنها الحلاج الصوفي بقوله: "وقد كان يرتدى جبة "ما الجبة إلا الله"، والعقيدة الثانية معناها أن ذات الله موزَّعة على كل أجزاء الكون، فهي موجودة في كل إنسان وحيوان وطير ونبات وجماد، فلا فرق بين الله وبين عباده؛ إذ إن مجموع العباد هم جزء من ذات الله، وإن ذات الله هي ذات الكون، وهاتان العقيدتان دخلتا على بعض ضلال المتصوِّفة من الديانات الهندية، ومؤدَّى هاتين العقيدتين خروج الإنسان الذي حلَّت فيه ذاتُ الله أو خروج الناس جملةً؛ باعتبارها ذات الله من دائرة العبودية، ومن ثم تسقط عنهم جميعًا التكاليف الشرعية ويعبر عن هذا المعنى قائلهم:
الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف؟
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت ربٌّ أنَّى يكلَّف
والمؤمنون يعلمون أن هاتين العقيدتين من أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين، وأن الله ليس كمثله شيءٌ، وأنه لا يمكن أن يحل في مخلوقاته، وأنه مباينٌ لخلقه، وأن أحدًا لا يخرج من العبودية بحال؛ فرسول الله- صلى الله عليه وسلم- أُمِرَ بالعبادة حتى الوفاة كما سبق، وهو أعلى العباد منزلةً وأشرفهم على الله قدرًا، وعنده مكانةً.
- ويعتقد بعض الناس أن لبعض المشايخ والعلماء حقَّ التحليل والتحريم، وحقَّ إنشاء عبادات يتقربون بها إلى الله، وحقَّ تشريع مناهج لهم في سائر حياتهم عليهم أن يلتزموها، كل ذلك بغير إذن من الله ولا سلطان، وهذا الذي يعتقدون إنما يَخرُجُ معتقدُه من دائرة العبودية لله ويوقعه لا محالة في الإشراك به وعبودية أولئك الشيوخ؛ إذ إن التشريع حقٌّ خالصٌ لله تعالى ابتداءً، وقديمًا اتبع اليهود والنصارى رهبانهم وأحبارهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلَّ الله؛ فقال تعالى فيهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا..﴾ (التوبة: من الآية 31)، وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى من الآية 21).
وكذلك اعتبار آراء الرجال حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلَّت عليه السمعيات أي النصوص، ثم حمل نصوص الكتاب والسنة على هذه الأقوال حملاً متعسِّفًا أو الإعراض عن النصوص، أو تقديم الأذواق والأهواء والمواجيد على أحكام الله وعلى نصوص الكتاب والسنة.
كل ذلك من الضلالات التي تخرج بالعبد من دائرة العبودية الحقَّة، أما المؤمن الصحيح فموقفه من النصوص كموقف العالم من التجربة العملية لا يفرض عليها رأيًا ولا يفسرها بهوى، وإنما يلتزم بالنتائج كما هي، وكذلك المؤمن فهو لا يخضع النص لرأيه، ولكنه يُخضع رأيه للنص ويلتزم في فهمه بالقواعد والضوابط الشرعية ولا يقدم عليه هواه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله﴾ (الحجرات: من الآية 1).
- ومن دواعي الخروج من دائرة العبودية الإفراط في دعوى الحب لله تعالى، حتى يؤدي ذلك إلى الإدلال عليه، والقول بعدم الخوف منه ولا الرجاء فيه، والعبودية كما قلنا منتهى الذلّ مع منتهى الحب، والذل والخضوع مصدرهما الخوف والرجاء أو الرهبة من عذابه والرغبة في رحمته وجنته، وبهذين الوصفَين وصف تعالى أنبياءه؛ فقال عن زكريا عليه السلام وأهله ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (الأنبياء: من الآية 90) والرسول يقول "إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له.." وكثيرًا ما يترتب على ذلك الإدلال التفريط في الأحكام الشرعية بدعوى المحبة، وهؤلاء مثلهم كمثل اليهود والنصارى؛ حيث قالوا ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ (المائدة: من الآية 18) فردَّ الله تعالى عليهم بقوله: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ (المائدة: من الآية 18).
- من البدع العملية ذكر الله تعالى باسمه المفرد؛ بدعوى أن هذا هو ذكر الخاصة، وأن الذكر بالاسم المضمر هو ذكر خاصة الخاصة، والذكر بالاسم المفرد المظهر أن يقول القائل: الله، الله، الله، أو رحيم، رحيم، رحيم.. وهكذا، والذكر بالاسم المضمر أن يقول القائل: هو، هو، هو.. إلخ؛ وهذا ضلال مبين فهذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو صفوة الله من خلقه يقول: "أفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله"، ويقول: "أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله"، ويقول: "أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" ويقول: "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".
والمتتبِّع لذكر المصطفى- صلى الله عليه وسلم- يعلم أنه ما كان يذكر الله تعالى أبدًا إلا بكلام تامٍّ أو جملة مفيدة، والخروج عن عمله عليه الصلاة والسلام بدعة مردودة؛ قال- صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ".
وثمة اعتراضات يحتج بها المبتدعون، منها قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأنعام: من الآية 91) ولو قرأنا الآية كاملةً لعلمنا بطلان استدلالهم بها يقول تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأنعام: من الآية 91) أي الله هو الذي أنزل الكتاب، فهو جواب الاستفهام.
ومنها دعوى الخوف أن يموت الذاكر بين النفي والإثبات في جملة لا إله إلا الله؛ فيخشى أن يموت بعد قوله لا إله فيموت كافرًا، وهذا باطل؛ لأن الله يعلم المقاصد والنيات ويحاسب عليها، كما أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قد أمر بتلقين المحتضر "لا إله إلا الله"، فلو كان الأمر كما يزعمون لكان تلقينه كلمة "الله" هو الأَولى؛ خشية أن يموت بين النفي والإثبات، خصوصًا وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة.
كما أن الذكر باللفظ المظهر لا يفيد نفيًا ولا إثباتًا، كما أنه لا يعطي القلب معرفةً مفيدةً، ويزعم القائلون بالذكر باللفظ المضمر أن دليلهم قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ﴾ (آل عمران: من الآية 7) فيقولون أن صحته "وما يعلم تأويل هو إلا الله" "أي لا يعلم معنى أو حقيقة كلمة هو إلا الله، وهذا من أبطل الباطل؛ إذ إن الضمير المضمر في كلمة (تأويله) عائد على المتشابه في القرآن الكريم يعلم ذلك كل من قرأ الآية كاملةً في أول سورة "آل عمران".
نسأل الله الكريم أن يرزقَنا حقيقةَ العبودية له؛ حتى نتحرَّر من عبودية كل ما سواه، وصلى الله عليه وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.