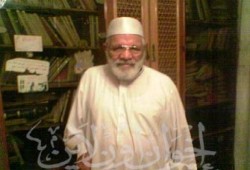بقلم: محمد خير موسى
"في تحوّل عظيم، صار المجتمع يعظّم أيّما تعظيم المرونة في قلب الأشياء رأسا على عقب، والتخلص منها، والتخلي عنها، فضلًا عن الروابط الإنسانية التي يسهل حلّها والفكاك منها، والواجبات التي يسهل الرجوع عنها، وقواعد اللَّعِب التي لا تدوم أطول من زمن اللّعبة، فقد أُلقي بنا جميعا في سباق نلهث فيه وراء كل جديد"!
هكذا عبّر "زيجمونت باومان" في كتابه "الحداثة السائلة" عن واقع المجتمعات البشرية في ظلّ عالم ما بعد الحداثة.
في مواجهة الفردانية
من أهم سمات ما بعد الحداثة علوّ النزعة الفردانية، ونقصد بها النزعة الاجتماعية التي تُعلي قيمة الفرد المعنوية بشكل أنانيّ، وتقوم على التمركز حول مفهوم الإشباع العاطفي والبدني والتعليمي والتسويقي والترفيهي للفرد؛ فهي تجعل أهدافه ورغباته وطموحاته، بل شهواته ونزواته والسعي إلى إشباعها وتحقيقها، أهمّ بكثير من الانخراط في المجتمع والانتماء إلى أفكاره وتوجهاته وقضاياه؛ بل إنها تبتر الإنسان عن محيطه، فلا يشعر بالانتماء إلى مجتمعه أو أمته وقضاياهما، ويصل الأمر إلى اعتبار أية محاولة لتحميله مسؤولية قضايا مجتمعه أو أمته انتهاكا لخصوصيته وتقييدا لحريته.
وفي كتابه "بؤس الدهرانيّة"، يرى الدكتور طه عبد الرحمن أن "الحداثة الغربية التي أقامت مشروعها على الدنيا والمادة سعت لتعطيل دَور الدين في مجالات الحيوية، وكان الفصل أحد أدواتها ووسائلها، وكان أبرز مجالات الفصل: الدين عن العلم، والسياسية عن الأخلاق. كذلك أصبح الفرد يعيش تصورات جزئية، تظلّله رغبة عدم المشاركة مع الآخرين، واتّسم طابع حياته بالأنانية، والرغبة في التحلل من قيود المسئولية الاجتماعية، لذا كان العزوف الكبير عن الزواج، والتخلي عن مسؤوليات الأسرة”.
في هذا العصر، الذي يعزّز الأنانية، ويزرع في الجيل مبدأ "أنا – بل ملذاتي- ومن بعدي الطوفان"، تغدو دراسة السيرة النبوية من الضرورة بمكان لمواجهة هذه النزعة الفردانيّة وتجلياتها وآثارها، ففي تفاصيل السيرة وحياة النبي صلى الله عليه وسلّم نجد نموذج الإنسان الرساليّ، الذي عاش حياته ليعطي لا ليأخذ، وكان همُّه أمّتَه ومجتمعه، وكانت آلامه من أجل الآخرين لا من أجل تحقيق الرغبات الذاتيّة.
من أوّل لحظة نزل فيها أمر الله تعالى لنبيّه بالتبليغ {يا أيُّها الْمُدَّثِّر * قُمْ فَأَنذر} إلى أن اختار الرفيق الأعلى، ورأسه على صدر عائشة رضي الله عنها، وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم إلى باريها، لم يهدأ لحظة ولم يرتح ساعة، ولم يتدثّر بعد أن ألقى عنه دثار الراحة، بل إن هذه الخصيصة من خصائص النبي الخاتم عليه أزكى الصلوات وأتمّ التسليم مستمرة إلى يوم القيامة، فبعد أن يطيل رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود تحت العرش ويقال له: “يا محمَّد، ارفع رأسك، وقل يُسمَع لك، وسَلْ تُعطَه، واشفع تُشفَّع” فلا يكون همّه في تلك الساعة التي يفرّ فيها المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه إلا أن يقول: “ربّ، أُمَّتي أُمَّتي”
فعندما يعيش المرء مع تفاصيل السيرة النبوية لا يجد محض أوامر نظرية، بل سلوكا عمليّا يقضي على النزعة الفردانيّة في النفس الإنسانية، ويجعل الفرد جزءا من مجتمعه وقضاياه، فعندما يعيش الإنسان مع حادثة الهجرة ــ على سبيل المثال ــ يجد كيف حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إشراك كل شرائح المجتمع في صناعة أعظم حدث عرفته البشرية، في تحويل الدعوة إلى دولة، والفكرة إلى كيان سياسي واجتماعي؛ وهو الهجرة إلى المدينة؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهاجر بمفرده بكل يُسرٍ ورعاية من الله تعالى، وكان يمكن أن يحمله الله تعالى على البراق فيصل المدينة في طرفة عين؛ غير أنه أشركَ في صناعته المرأة أسماء رغم أنها كانت حاملا، والشابّ عبدالله، والكهل أباهما أبا بكر الصديق، رضي الله عنهم، وأشرك الشاب الفدائي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأشرك راعي الأغنام عامر بن فهيرة رضي الله عنه، والدليل غير المسلم مأمون الجانب الكفء في مهمته عبدالله بن أريقط، في رسالة بالغة الوضوح أن الأحداث الكبيرة لا يصنعها الفرد مهما كان فذًّا، بل يصنعها المجموع بتضافره وتكامله وتعاونه، والسيرة النبوية زاخرة بالأحداث التي تربّي الفرد على هذه المزيّة والخصلة.
من عاش السيرة النبوية وجد فيها حصنًا من النزوع إلى الفردانيّة، التي تهيمن على فكر وسلوك كثير من الشباب الغرقى في حمأة تأثيرات ما بعد الحداثة.
في مواجهة التفاهة وترميز التافهين
من أبشع ما أنتجته النزعة الاستهلاكية والمادية في عصر ما بعد الحداثة؛ طوفان التفاهة الذي غدا نظاما مدعوما يوصل مجتمعاتٍ شبابيّة كاملة إلى فقدان المعنى، كما يقول الفيلسوف الكندي "آلان دونو" في كتابه "نظام التفاهة": "التفاهة تشجّعنا بكل طريقة ممكنة على الإغفاء بدلا من التفكير، والنظر إلى ما هو غير مقبول وكأنه حتمي، وإلى ما هو مقيت وكأنه ضروري؛ إنها تحيلنا إلى أغبياء".
وفي عصر الانفجار التواصلي صارت عملية صناعة الرموز أكثر سهولة وأكثر كارثيّة في آنٍ معًا، وفي ذلك يقول “آلان دونو”: “نجحت مواقع التواصل في ترميز التافهين، أي تحويلهم إلى رموز، فصار يمكن لأية جميلة بلهاء أو وسيم فارغ، أن يفرضوا أنفسهم على المشاهدين، عبر عدّة منصات تلفزيونية عامة، هي في أغلبها منصات هلامية وغير منتجة، لا تخرج لنا بأيّ منتج قيمي صالح لتحدّي الزمان”.
وفي هذا العصر الذي نشهد فيه طوفان التفاهة وترميز التافهين يجد من يعيش مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمةً وملجأً من الغرق في هذا الطوفان، ففي السيرة منهجيّات عمليّة لتبني القضايا الكبرى وتجنب السفاسف والتفاهات، وبيان عمليّ لكيفية إخراج المجتمع الذي كان غارقا في الظلمة والتقاتل لأجل القضايا التافهة، كاشتعال الحروب بسبب بعض المنافسات الرياضية والتقاتل لأجل التقرّب من امرأة جميلة، أو لأجل ملكيّة فرس أو ناقة؛ فأخرجهم الإسلام من هذا الدرك ليعيش أفراده لأجل قضايا كبرى ويموتوا في سبيل رسالة عظيمة.
كما أن السيرة النبوية هي المصدر الثرّ لمواجهة فكرة الخلاص الفردي، التي ينزع إليها كثير من الناس اليوم، ويظنّون أنّ فيها نجاتهم من تأثيرات ما بعد الحداثة، ومنها طوفان التّفاهة، ولئن كان “آلان دونو” قد نبّه إلى أن مواجهة التفاهة لا تكون إلا بالقطيعة الجمعيّة، فإننا نرى أن السيرة النبوية زاخرة في تربية الفرد على أن خلاصه لا يكون إلا بالنهوض بالمجتمع كله، وبتضافر المجتمع على مواجهة ما يحيق به من معارك وتحديات، فالمجتمع كله يتضافر لمواجهة محاولات بثّ الشائعات التي تهدد تماسكه، كما كان في حادثة الإفك، والمجتمع كله يتضافر لتنفيذ العقوبة بحق الثلاثة الذين تخلّفوا يوم العسرة يوم تبوك، فيسجنهم في أندر حبس عرفته البشرية، فيكونون أحرارا في البيئة الواقعية، غير أن القطيعة الجمعيّة جعلت الأرض تضيق عليهم بما رحبت، وتضيق عليهم أنفسهم في مشهد عجيب لتضافر المجتمع كلّه منفِّذًا الأوامر النبويّة، لعلاج ظواهر سلبية قد تعصف بكيانه كله.
وكذلك في السيرة تجسيد للرمز الأهم في حياة المسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وتربية على حبّه؛ الحب الذي يدفع للامتثال والاقتداء والتأسّي، ومعه أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، الذين سيجد الجيل المسلم الرموزَ التي تستحق الاقتداء فيهم، لا في ما يراد فرضه عليه من رموز تافهة، تربي النشء على ممارسة أفعالٍ تافهة أو غير ذات قيمة حقيقيّة.
هكذا تغدو السيرة النبوية، ودراستها والحياة معها وتأمُّل تفاصيلها واستنباط دروسها وتمثّل معانيها، ضرورةً لحفظ الإنسان من الغرق والتيه في لجّة ما بعد الحداثة المعتمة، ومواجهة الفردانيّة القاتلة لروح المجتمع الأمة، ومجابهة التفاهة القاضية على كيان الشباب المسلم.. هي السيرة النبويّة، التي إن عاشها المرء بعقله وروحه صنعت له الحياة، والتي يعيش فيها الإنسان إنسانيّته بحقّ، ويلقى سعادته الحقيقيّة بعد أن يجد نفسه.